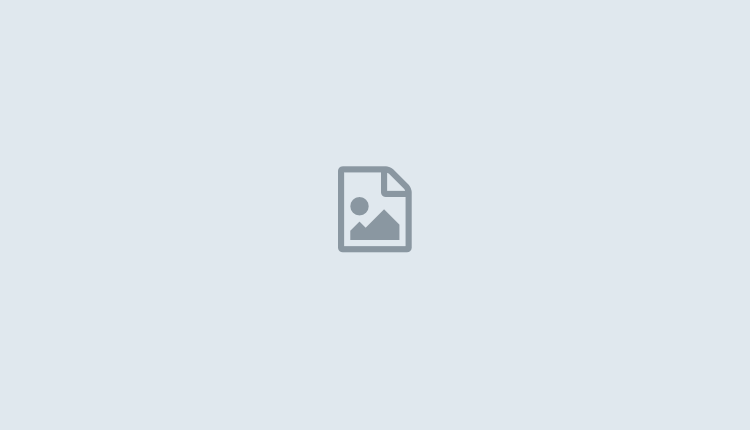مبعوثا الهند وباكستان في مجلس الأمن يتبادلان اتهامات بالإرهاب
بعد أن تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا، أمس الخميس، حذر فيه من تزايد مخاطر الإرهاب، تبادل مبعوثا الهند وباكستان بشدة الاتهامات بإلقاء اللوم بعضهما على بعض في الهجمات الإرهابية.
لم يسمّ وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار باكستان في خطابه أمام مجلس الأمن.
لكن في رده على أسئلة الصحافيين بعد ذلك، أشار إلى قول وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، خلال زيارة لباكستان قبل عقد من الزمان: “إذا أبقيت الثعابين في الفناء الخلفي لمنزلك، فلا تتوقع منها أن تعض جيرانك فحسب، بل في النهاية سوف تعض الناس الذين يحتفظون بها في الفناء الخلفي”.
وقال جايشانكار: “باكستان ليست جيدة في العمل بالنصائح الطيبة. العالم اليوم يعتبرها بؤرة الإرهاب”.
في وقت سابق، قال للمجلس إن “الهند واجهت أهوال الإرهاب العابر للحدود قبل وقت طويل من تعامل العالم معه بجدية”، و”حاربت الإرهاب بحزم وشجاعة وبنهج عدم التسامح”.
وقال إن الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، وهجوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 الإرهابي، الذي أودى بحياة 166 شخصًا في مومباي بالهند، يجب ألا يتكررا أبدًا.
وكان مهاجمو مومباي العشرة أعضاء في عسكر طيبة، وهي جماعة مسلحة مقرها باكستان، وقال محققون هنود في وقت لاحق إن أفعالهم كانت موجهة عبر الهاتف من قبل موجهين في باكستان.
وطُلب من وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري الرد على ادعاء جايشانكار بأن العالم يرى أن باكستان “بؤرة الإرهاب” في مؤتمر صحافي بعد فترة وجيزة.
وقال بوتو زرداري إن باكستان كدولة كانت ضحية للإرهاب، وإنه كفرد ضحية للإرهاب – والدته، بينظير بوتو، أول امرأة انتخبت لقيادة دولة ذات أغلبية مسلمة في عام 1988، اغتيلت على يد مفجر انتحاري هرع إلى موكبها أثناء حملتها الانتخابية لمنصب الرئيس في عام 2007.
وقالت بوتو زرداري إن محاربة الإرهاب كانت قضية “شخصية للغاية بالنسبة لي”.
(أسوشييتد برس)
القمة الأفريقية – الأميركية… محاولة للتخلص من نفوذ الصين
اختتمت القمة الأفريقية – الأميركية، ليل الخميس، أعمالها في واشنطن، بعد ثلاثة أيام من النقاشات والمباحثات واللقاءات عالية المستوى التي لم تنشغل بها العاصمة، بقدر ما انشغلت بالتدابير الأمنية الاستثنائية التي فرضتها، والتي عطّلت الحركة في قسم حيوي من العاصمة، بإقفال العديد من الشوارع، أو تغيير وجهة السير، وكثرة الحواجز فيها.
ونال هذا الجانب معظم أضواء التغطية والمتابعة الشحيحة للقمة، على الرغم من مشاركة رؤساء وقيادات ومسؤولين كبار من 49 دولة أفريقية، وهو تجمع ندر أن عرفت واشنطن بحجمه. مع ذلك، بقي حضوره الإعلامي بشكل خاص أقل بكثير من مستوى الحدث، ربما لأن التوقعات بشأن القمة كانت متواضعة، قياساً بما انتهت إليه القمة المماثلة في 2014، والتي كانت أقرب إلى تجمع علاقات عامة، من دون أي مردودات أميركية لصالح القارة السوداء.
والاعتقاد أن السيناريو نفسه سيتكرر مع هذه القمة، التي يكاد يجمع العارفون بأن الغرض الأساسي من عقدها لا علاقة له باستنهاض القارة، بقدر ما هو مصوّب للمضاربة على علاقاتها المتنامية مع الصين، أو على الأقل الحدّ منها، إن تعذر الخلاص من الحضور الصيني البارز والمتزايد فيها، وذلك في إطار سياسة “المنافسة” مع بكين التي تعتمدها إدارة الرئيس جو بايدن من البداية، والتي كادت تتطور إلى شيء من المواجهة في الصيف الماضي حول موضوع تايوان.
الإدارة لخصت القمة بـ”الشراكة” التي تنوي عقدها مع البلدان الأفريقية. المجالات شملت مروحة واسعة من الملفات والقضايا والتحديات التي تناولتها مداولات الأيام الثلاثة الماضية، والتي افتتحها الرئيس بايدن بوعد لتخصيص 55 مليار دولار على 3 سنوات، “لتعزيز أولوياتنا المشتركة”. شمل ذلك “التبادل التجاري، ومجالات الاستثمار، والأمن الغذائي، والمناخ، وتعزيز الديمقراطية، والانتخابات، والحكم الرشيد، والطاقة النظيفة، وقضايا المرأة…”.
وفي مؤتمر صحافي لتقييم القمة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن نتائجها “كانت إيجابية جداً، وحققت الكثير، لكن الأصعب ما زال أمامنا… والمزيد مطلوب إنجازه”.
نفس الخطاب تقريباً افتتحت واختتمت فيه القمة ذاتها في 2014. آنذاك كانت التوقعات متفائلة أكثر، على اعتبار أنها أول قمة من نوعها تُعقد في واشنطن، وأن الرئيس السابق باراك أوباما، المتحدر من عائلة أفريقية، سيضع وزن الرئاسة وراء ذلك الحدث، ليس فقط لإنجاحه، بل أيضاً للتعويض عن القصور الأميركي التاريخي تجاه القارة الأفريقية.
وعلى هذا الأساس، كانت التقديرات أن القمة قد تتحول إلى حدث دوري لمواصلة الشراكة وتطويرها، لكن ما حصل أن تلك القمة انتهت يتيمة، ولم يبقَ منها سوى شعارات سرعان ما تبخر حبرها، وتناست واشنطن القمة لمدة 8 سنوات، بقيت خلالها العلاقات بين الجانبين على حالها، ما ساعد على توسيع الفرصة أمام الصين، التي تسللت إلى القارة بأفق استراتيجي، وبتقديمات تنموية تصعب منافستها.
أرادت الإدارة الآن تقديم القمة كصحوة أميركية على أهمية “الشراكة” الأفريقية، لكن مقاربتها لا تستوفي شروط مثل هذه الصحوة. توسل المساعدات كمبدأ وكمدخل، سبق أن تبين أنه لا يؤدي إلى المطلوب. وحتى بلغة المساعدات والتحفيز، ما تقرر من مبالغ لا يحقق الغرض، رغم أهمية هذه الوسيلة، خصوصاً الشق المتعلق منها بالإعانات الإنسانية.
أفريقيا بحاجة إلى طفرة تنموية لتخرج من أزماتها المستعصية وأوضاعها الصعبة. وبشكل رئيسي، مديونيتها الكبيرة التي تستنزف موازناتها بسبب خدمة الديون التي جرى اقتراضها بفوائد عالية، خصوصاً الدول الأفريقية الفقيرة ذات التصنيف الائتماني الضعيف، الذي اضطرها إلى الاستدانة بفوائد فاحشة، وبما أقفل عليها باب الخروج من المديونية.
في الحالات الدولية المشابهة، تلجأ الدول للحصول على ضمانات موثوقة لديونها السيادية. والضامن عادة جهات مقتدرة مثل أميركا، تسهل على هذه البلدان عمليات التسليف التي تحتاجها. كما هي حالة أوكرانيا حالياً. الإدارة لم تأتِ على سيرة هذا الموضوع لا قبل القمة ولا أثناء انعقادها، وعندما سئل الوزير بلينكن عن هذا الموضوع، لم يأتِ على ذكر سيرة الضمانات. استعاض عن ذلك بإرشاد الدول الواقعة تحت عبء الديون إلى طلب العون من مؤسسات وتكتلات دولية مثل “مجموعة العشرين”، و”مبادرة البلدان الفقيرة المديونة بقوة”. والمعروف أن هذه الجهات تساعد فقط من باب تأمين إعفاءات وتخفيفات من جزء من خدمات الديون، وليس من تقليل سعر الفائدة عليها.
وإذا كانت قارة بهذا الحجم لا تقوى على تحصيل ضمانات أميركية للديون السيادية بفائدة لا تكسر عظم الدول الأفريقية الفقيرة، عندئذ يكون الحديث عن الشراكة والتنمية في غير مكانه؛ كما يكون تصنيف القمة كأداة للتصدي للصين في القارة أكثر من كونها لانتشال هذه الأخيرة من أزماتها، في محله.
وكادت الإدارة أن تفصح عن ذلك صراحة، حين قال وزير الدفاع لويد أوستن إن “النفوذ الصيني في القارة هو تهديد للاستقرار”. بلينكن تجاهل الرد على سؤال حول ملاحظة أوستن، وغمز ضمناً من زاوية الصين، عبر الإشارة إلى ما يُسمّى بـ”قروضها وعقودها” الملغومة التي تنطوي على التزامات إجبارية “وإكراهية” للمستفيدين الأفارقة. القمة جيوسياسية أكثر بكثير مما هي “شراكة”.